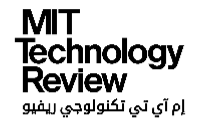على مدى نصف قرن من الزمن، كان باحثو المناخ يدرسون إمكانية حقن جسيمات صغيرة في طبقة الستراتوسفير لإحداث أثر معاكس لبعض نواحي التغيّر المناخي. وتعتمد الفكرة على استخدام هذه الجسيمات لعكس نسبة صغيرة من ضوء الشمس إلى الفضاء، ما يتيح إحداث تغير في اختلال الطاقة الناجم عن تراكم ثنائي أوكسيد الكربون، وهو ما يؤدي من ثم إلى خفض الاحترار وتخفيف العواصف الشديدة وغيرها من المخاطر المناخية الأخرى.
تمثّل هذه الفكرة أحد أنماط الهندسة المناخية الشمسية، وتُسمَّى حقن الهباء الجوي في الستراتوسفير أو "ساي" (SAI) اختصاراً، وعادة ما تركّز النقاشات حولها إمّا على بحث ميداني محدود النطاق لفهم العمليات الفيزيائية لهذه الطريقة، أو تطبيقها على مستوى كافٍ لإحداث تغيير شامل في المناخ. ثمة هوة كبيرة بين الأسلوبين، فقد تستهلك التجربة عدة كيلوغرامات من مادة الهباء الجوي وحسب، على حين يتطلب التطبيق الذي يمكن أن يؤدي إلى إبطاء الاحترار أو حتى عكس اتجاهه استخدام الملايين من الأطنان المترية من الهباء الجوي سنوياً، ما يعني فرقاً في المستوى بمقدار مليار ضعف. يحتاج تبريد الكوكب على نحو ملحوظ من خلال طريقة ساي أيضاً إلى أسطول مصمم خصيصاً لهذا الغرض من الطائرات القادرة على التحليق على ارتفاعات كبيرة، الذي قد يستغرق تجميعه عقداً أو عقدين من الزمن. هذه الفترة الطويلة اللازمة للإنجاز كافية لتشجيع صُنّاع السياسات على تجاهل القرارات الصعبة حول تنظيم تطبيق طريقة ساي،
لكن هذه الاستكانة ليست بالأمر الجيد، فقد يكون الحد الفاصل بين البحث والتطبيق أقل وضوحاً مما نفترض في أغلب الأحيان. تشير تحليلاتنا إلى أنه من الممكن أن تبدأ دولة أو مجموعة من الدول، على نحو عملي، تطبيق الهندسة المناخية الشمسية على نطاق محدود، وذلك خلال فترة قد لا تتجاوز الأعوام الخمسة، وقد تنجم عن هذا العمل تغييرات ملحوظة في تركيب الستراتوسفير. يمكن للتطبيق المحدود، عند إدارته جيداً، أن يفيد الأبحاث من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بساي، غير أنه لا يمكن تبريره بالأغراض البحثية وحسب، فمن الممكن إجراء أبحاث مماثلة باستخدام كميات أصغر بكثير من جسيمات الهباء الجوي. وسيكون له تأثير لا يستهان به على المناخ، حيث يوفّر قدراً من التبريد يعادل ما فعله التلوث الكبريتي الذي نجم عن عمليات الشحن البحري الدولية قبل تطبيق المعايير الجديدة على وقود الشحن البحري لتخفيف نسبة الملوثات فيه. في الوقت نفسه، سيكون مستوى التبريد صغيراً بما فيه الكفاية إلى حد يجعل اكتشاف آثاره في المناخ -على المستوى الوطني أو الدولي- صعباً للغاية في ظل التقلبات الاعتيادية.
وعلى حين سيكون الأثر المناخي لهذا التطبيق المحدود صغيراً (ومفيداً على الأرجح)، فإن الأثر السياسي قد يكون عميقاً، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى رد فعل سلبي من شأنه أن يُحدِث انقلاباً في العوامل الجيوسياسية المتعلقة بالمناخ، ويهدد الاستقرار الدولي. من الممكن أن يؤدي إلى تسارع الأمور نحو التطبيق الواسع النطاق، ومن الممكن أن تستغله الجهات المستفيدة من الوقود الأحفوري لصالحها من أجل إبطاء المهمة الأساسية التي تتمثل بتخفيف الانبعاثات.
نحن نعارض تطبيق الهندسة المناخية الشمسية على المدى القريب. ووفقاً للجنة تجاوز المناخ (Climate Overshoot Commission)، وهي أعلى مجموعة رفيعة المستوى من القادة السياسيين الذين يدرسون هذا الموضوع، فنحن ندعم تعليق التطبيق مؤقتاً إلى أن تنال الأسس العلمية الموافقة الدولية وتخضع لتقييم نقدي، وإلى أن توضع هيكلية إدارية مُتَّفق عليها على نطاق واسع. لكن إذا تبين لنا أن هذا التطبيق المحدود ممكن، فقد يحتاج صُنّاع السياسات إلى التعامل مع موضوع الهندسة المناخية -أي أهدافه الموعودة واحتمالات الزعزعة الناجمة عنه، والتحديات العميقة التي تواجه الإدارة العالمية- في وقتٍ أبكر مما هو مُفتَرَض على نطاق واسع اليوم.
اقرأ أيضاً: هل سيبدأ عصر الهندسة المناخية على الرغم من كل الأصوات المعارضة له؟
العوائق التي تقف في طريق التطبيق المبكر
يصدر البشر كميات هائلة من الهباء الجوي في طبقة التروبوسفير (وهي الطبقة الأخفض والأكثر اضطراباً في الغلاف الجوي) من مصادر مثل الشحن البحري والصناعات الثقيلة، لكن هذا الهباء الجوي يتساقط على الأرض، أو تزول بفعل هطول الأمطار وغيرها من العمليات خلال فترة أسبوع تقريباً. ويمكن للانفجارات البركانية أن تُحدِث آثاراً تدوم فترة زمنية أطول؛ فعندما تصل قوة الانفجار إلى درجة كافية لاختراق التروبوسفير وصولاً إلى الستراتوسفير، يمكن لمواد الهباء الجوي المترسبة هناك أن تبقى مدة سنة تقريباً. تعتمد طريقة ساي على حقن مواد الهباء الجوي أو المُركّبات التي تؤدي إلى تشكلها في طبقة الستراتوسفير، على نحو مماثل للانفجارات البركانية الكبيرة. تدوم مواد هذا الهباء الجوي التي توضع في الغلاف الجوي فترة أطول بكثير، ما يعني أن تأثيرها في التبريد أقوى بمائة مرة من تأثيرها إذا أصدرت عند مستوى سطح الأرض، غير أن إيصال مواد الهباء الجوي إلى الستراتوسفير مسألة أخرى.
عادة ما تصل طائرات الركاب النفاثة إلى الجزء المنخفض من الستراتوسفير خلال الرحلات العابرة للمنطقة القطبية. لكن تحقيق تغطية عالمية فاعلة يستوجب إطلاق مواد الهباء الجوي على ارتفاعات أقل، حيث تحملها التيارات الطبيعية المتقلبة للستراتوسفير نحو القطب، ومن ثَمَّ توزعها على أنحاء العالم كافة. يصل الارتفاع المتوسط للجزء العلوي من التروبوسفير إلى 17 كيلومتراً تقريباً في المناطق الاستوائية، وتشير النماذج إلى أنه يجب حقن الهباء الجوي على ارتفاع أعلى ببضعة كيلومترات من هذا حتى تلتقطه تيارات الستراتوسفير الصاعدة. عادة ما يُحدد الارتفاع الأكثر فاعلية لنشر الهباء الجوي بقيمة 20 كيلومتراً على الأقل، أي ما يقارب ضعف ارتفاع الرحلات البعيدة المدى للطائرات التجارية النفاثة أو الطائرات العسكرية الكبيرة.
وعلى الرغم من أن طائرات التجسس الصغيرة قادرة على قطع مسافات كبيرة في هذا الهواء الذي يتسم بكثافة منخفضة للغاية، فإن حمولتها لا تتجاوز طناً مترياً أو اثنين وحسب. هذه الحمولة غير كافية، إلّا في حالات الاختبارات المحدودة، حيث تتطلب إزاحة الاحترار العالمي بنسبة ملحوظة -مثل تبريد بمقدار درجة مئوية واحدة- استخدام منصات قادرة على نشر عدة ملايين من الأطنان المترية من هذه المواد في الستراتوسفير كل عام. لا يمكن استخدام الصواريخ أو المناطيد لحمل هذه الكتل الضخمة إلى ارتفاعات كبيرة كهذه. ولهذا، يتطلب التطبيق الكامل للهندسة المناخية أسطولاً من الطائرات الجديدة، حيث سنحتاج إلى بضع مئات من هذه الطائرات لتحقيق هدف التبريد بمقدار درجة مئوية واحدة. من الممكن أن يستغرق تصنيع الطائرة الأولى على نحو مماثل لبرامج تطوير الطائرات التجارية أو العسكرية الكبيرة عقداً من الزمن تقريباً، أمّا تصنيع الأسطول المطلوب فسوف يستغرق بضعة أعوام إضافية.
لكن البدء بتطبيق الهندسة المناخية على نطاق واسع عمل متهور ومستبعد في الوقت نفسه؛ فحتى إذا تمكنا من خفض حرارة الكوكب، فإن زيادة سرعة تغييرنا للمناخ ستزيد من أخطاء الآثار غير المتوقعة. من المرجّح أن تكون الدولة أو مجموعة الدول الراغبة في تطبيق الهندسة المناخية الشمسية أكثر تقديراً للإيجابيات السياسية والتقنية للانطلاقة بوتيرة أبطأ، مع عكس تدريجي للاحترار يسهّل الحصول على أفضل النتائج و"التعلم من خلال التطبيق"، مع خفض احتمال العواقب غير المقصودة وآثارها.
نتصور بعض السيناريوهات التي تبادر فيها دولة أو مجموعة من الدول إلى وضع مقدار أصغر من المواد في المنطقة المنخفضة من الستراتوسفير على ارتفاعات أعلى، بدلاً من محاولة حقن الهباء الجوي قرب خط الاستواء باتباع أكثر الطرق فاعلية. ويمكن تنفيذ هذه العملية باستخدام الطائرات الموجودة حالياً، لأن ارتفاع الطبقة العليا من التروبوسفير ينخفض انخفاضاً حاداً مع الابتعاد عن خط الاستواء. فعند خط العرض 35 درجة شمالاً وجنوباً، يبلغ ارتفاع هذه المنطقة 12 كيلومتراً تقريباً. وبإضافة هامش بقيمة 3 كيلومترات، يبلغ ارتفاع النشر الفعّال على خط العرض 35 درجة شمالاً وجنوباً قيمة 15 كيلومتراً. ما زال هذا الارتفاع كبيراً للغاية بالنسبة للطائرات، لكنه أقل بقليل من الحد الأقصى لعمل أحدث طائرات الأعمال النفاثة التي تصنعها شركات غولف ستريم (Gulfstream) وبومباردييه (Bombardier) وداسو (Dassault)، الذي يبلغ 15.5 كيلومتر. تتضمن قائمة البلدان التي يخترق أراضيها خط العرض 35 درجة شمالاً أو جنوباً بعض البلدان الثرية، مثل الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا والصين، لكنها تشمل أيضاً بعض البلدان الأفقر، مثل المغرب والجزائر والعراق وإيران وباكستان والهند وتشيلي والأرجنتين.
اقرأ أيضاً: إحدى التجارب الأولى من نوعها في الهندسة المناخية على وشك الانطلاق
تطبيق محدود
كيف يمكن تحقيق التطبيق المحدود؟ تفترض معظم الدراسات العلمية التي أُجرِيَت على طريقة حقن الهباء الجوي أن المادة المستخدمة هي غاز ثنائي أوكسيد الكبريت (SO2)، التي تبلغ نسبة الكبريت فيها 50% من حيث الكتلة. ومن الخيارات الممكنة الأخرى كبريتيد الهيدروجين (H2S)، الذي يخفّض متطلبات الكتلة إلى النصف تقريباً، غير أنه أخطر على الطواقم الأرضية وطواقم الطيران من ثنائي أوكسيد الكبريت، ما قد يعني التخلي عن فكرة استخدامه. أمّا غاز ثنائي كبريتيد الكربون (CS2) فيخفض متطلبات الكتلة بنسبة 40%، وهو عموماً أقل خطراً من ثنائي أوكسيد الكبريت. من المحتمل أيضاً استخدام الكبريت النقي، وهو الأفضل من حيث الأمان وسهولة الاستخدام، لكن هذا سيتطلب إيجاد طريقة لإحراقه على متن الطائرة قبل إطلاقه إلى الخارج، أو استخدام نظام الحارق اللاحق (afterburner) في الطائرات النفاثة. لم يُجرِ أي باحث حتى الآن الدراسات الهندسية المطلوبة لتحديد الخيار الأفضل بين مركبات الكبريت هذه.
بناءً على بعض الافتراضات التي أكدتها شركة غولف ستريم، تشير التقديرات إلى أن أي طائرة من طائراتها من طراز G500 أو G600 قادرة على رفع ما يقارب 10 آلاف طن من المواد إلى ارتفاع 15.5 كيلومتر كل عام. فإذا استخدمنا مادة ثنائي كبريتيد الكربون (CS2)، التي تتسم بفاعلية عالية بالنسبة للكتلة، يمكن لأسطول لا يتجاوز 15 طائرة رفع 100 كيلوطن من الكبريت كل عام. تكلف الطائرات المستعملة الصالحة للعمل من طراز G650 ما يقارب 25 مليون دولار. وإذا أضفنا تكلفة التعديلات والصيانة وقطع الغيار والرواتب والوقود والمواد والتأمين، نتوقع أن تصل التكلفة الوسطية لتطبيق الهندسة المناخية على نطاق محدود وعلى امتداد عقد من الزمن إلى ما يقارب 500 مليون دولار كل عام. أمّا تطبيق الهندسة المناخية على نطاق واسع فسوف يكلف 10 أضعاف هذا المبلغ على الأقل.
ماذا تكافئ كمية 100 كيلو طن من الكبريت كل عام؟ تكافئ هذه الكمية نسبة 0.3% وحسب من الانبعاثات العالمية السنوية الحالية من ملوثات الكبريت في الغلاف الجوي. وسيكون تأثير هذا الملوث الهوائي على الصحة أقل بكثير من عُشر تأثير هذه الكمية في حال إطلاقها عند مستوى سطح الأرض. أمّا بالنسبة للتأثير في المناخ، فسوف يكافئ 1% تقريباً من تأثير الكبريت الذي حُقِن في الغلاف الجوي بفعل ثوران جبل بيناتوبو البركاني في الفلبين عام 1992. يدعم هذا الحدث الذي حظي بقدرٍ وافٍ من الدراسة الرأي الذي يقول إننا لن نشهد تأثيرات مجهولة وذات عواقب فادحة.
وفي الوقت نفسه، فإن 100 كيلو طن من الكبريت كل عام ليس مقداراً يمكن إهماله، فهو أكثر من ضعف التدفق الطبيعي للكبريت من التروبوسفير إلى الستراتوسفير، دون وجود أي نشاط بركاني غير اعتيادي. سيكون أثر التبريد كافياً لتأخير الاحترار العالمي مدة تقارب ثُلث العام، وهو انزياح يمكن أن يدوم مع تواصل النشر المحدود لهذه المواد. وبما أن الهندسة المناخية الشمسية أكثر فاعلية في معاكسة أثر الأمطار الغزيرة منها في معاكسة ارتفاع الحرارة، فإن تطبيقها قد يؤخّر تزايد شدة الأعاصير الاستوائية أكثر من ستة أشهر. لا يمكن تجاهل هذه الفوائد بالنسبة للشرائح الأكثر عرضة لمخاطر الآثار المناخية، على الرغم من أن هذه الفوائد لن تكون واضحة بالضرورة نظراً للتقلبات الطبيعية في النظام المناخي.
من الجدير بالذكر أن السيناريو الذي يعتمد على نشر 100 كيلو طن في العام ليس سوى سيناريو كيفيّ وحسب. ونعرّف النشر المحدود بأنه يعني نشر كمية كبيرة بما يكفي لزيادة مقدار الهباب الجوي في الستراتوسفير بصورة ملحوظة، مع بقاء هذه الكمية أقل بكثير من الكمية اللازمة لتأخير الاحترار مدة عقد من الزمن. وفقاً لهذا التعريف، يمكن للنشر المحدود أن يكون أكبر أو أصغر بعدة أضعاف من هذا السيناريو الافتراضي.
بطبيعة الحال، لا يستطيع أي مستوى من الهندسة المناخية الشمسية إلغاء الحاجة إلى تخفيف تراكيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وتمثّل الهندسة المناخية الشمسية في أحسن الأحوال إجراءً متمماً لعمليات خفض الانبعاثات. غير أن الهندسة المناخية الشمسية يمكن أن تكون إجراءً متمماً ذا أثر واضح حتى وفق سيناريو النشر المحدود الذي طرحناه هنا: فقد يكون لهذا السيناريو على مدى عقد كامل تأثير مُبرّد يكافئ تقريباً نصف التأثير الناجم عن إيقاف انبعاثات كافة من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: 6 دروس يمكن أن نتعلمها من مرحلة الازدهار التي تشهدها التكنولوجيا المناخية
النواحي السياسية للنشر المحدود
يمكن للنشر المحدود الذي تحدثنا عنه هنا أن يخدم العديد من الأهداف العلمية والتكنولوجية المعقولة. فمن الممكن أن يُستَثمر في تجريب تكنولوجيات التخزين والرفع والنشر التي قد تُستَخدم في تطبيق الهندسة المناخية الشمسية على نطاق واسع. وإذا طُبِّق هذا النشر مع برنامج مراقبة، فمن الممكن أن يُتيح تقييم قدرات المراقبة أيضاً. حيث سيوضح بصورة مباشرة كيفية حمل الكبريتات عبر أرجاء طبقة الستراتوسفير وكيفية تفاعل هباء الكبريتات مع طبقة الأوزون. وبعد بضعة أعوام من هذا النشر المحدود، سيصبح لدينا تصور أفضل بكثير حول العوائق العلمية والتكنولوجية التي تقف في طريق النشر الواسع النطاق.
في الوقت نفسه، يمكن للتطبيق المحدود للهندسة المناخية الشمسية أن يشكّل مخاطر على الدولة التي تنفذ هذا العمل. فمن الممكن أن يحرض على الاضطرابات السياسية، ويستجلب إجراءات عقابية من البلدان الأخرى والهيئات الدولية التي لا تتعامل بإيجابية مع الكيانات التي تعبث بحرارة الكوكب دون تعاون وإشراف دوليين. من المحتمل أن تنبع المعارضة من النفور العميق تجاه العبث بالبيئة، أو من مخاوف أكثر واقعية من أن التطبيق الواسع النطاق قد يضر ببعض المناطق.
قد تنشأ الدوافع لدى الدول الراغبة في تطبيق هذه الطريقة من نطاق واسع من الاعتبارات المختلفة. ومن الواضح أن أي دولة أو ائتلاف من الدول قد يستنتج أن الهندسة المناخية الشمسية قد تؤدي إلى الحد من المخاطر المناخية لديها بدرجة كبيرة، وأن التطبيق المحدود للهندسة المناخية الشمسية يمكن أن يحقق توازناً فعّالاً بين أهداف دفع العالم نحو تطبيقها على نطاق واسع، وتقليل مخاطر ردود الفعل السلبية السياسية.
من الممكن أن ترى الدول التي ستطبّق المشروع المحدود أنه سيسهّل تحقيق إجراءات أوسع نطاقاً. وعلى حين قد يفضّل العلماء التوصل إلى الاستنتاجات حول الهندسة المناخية الشمسية من التجارب والنماذج الصغيرة، فقد يكون السياسيون والعامة أكثر حذراً بكثير بشأن التدخلات الجوية التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير النظام المناخي والتأثير على المخلوقات الموجودة ضمنه كافة. ومن الممكن للتطبيق المحدود الذي لا ينطوي على مفاجآت كبرى أن يحقق الكثير من حيث تخفيف المخاوف العميقة إزاء التطبيق الواسع النطاق.
أيضاً، يمكن للدول المبادِرة أن تزعم أنها حصلت على بعض الفوائد المحدودة من التطبيق المحدود بحد ذاته. وعلى حين قد تكون التأثيرات صغيرة للغاية بحيث لا يمكن إثبات وجودها على الأرض مباشرة، فإن الأساليب المستخدمة لربط الظواهر الجوية المتطرفة مع التغير المناخي يمكن أن تعزز المزاعم بحدوث انخفاضات صغيرة في شدة هذه الظواهر.
من الممكن أن تقول هذه الدول أيضاً إن تطبيق المشروع سيُعيد ببساطة حماية الغلاف الجوي التي فقدناها مؤخراً. لقد أدّى خفض نسبة الكبريت في انبعاثات السفن حالياً إلى إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز نظافة الهواء، لكنه يؤدي أيضاً إلى تسريع الاحترار من خلال تقليل كثافة الحجاب العاكس الذي أدّى هذا التلوث إلى ظهوره. ومن الممكن لسيناريو التطبيق المحدود أن يُعيد ما يقارب نصف هذه الحماية من ضوء الشمس، دون التلوث المرافق لها.
قد تعتبر الدول التي ستطبق هذا المشروع أيضاً أن أفعالها متوافقة مع القانون الدولي، لأنها قادرة على تطبيق المشروع بالكامل ضمن مجالها الجوي السيادي، ولأن آثار هذا العمل، على الرغم من أنها عالمية، لا يمكن أن تؤدي إلى "ضرر كبير عابر للحدود"، وهو العتبة المهمة بموجب القانون الدولي العرفي.
تعتمد الآثار الإدارية الناجمة عن هذا التطبيق المحدود على الظروف السياسية. فإذا بادرت إحدى القوى الكبرى إلى تطبيق الهندسة الشمسية المناخية على نطاق محدود دون أي محاولات جادة للمشاركة المتعددة الأطراف، فمن الممكن أن نتوقع ظهور ردات فعل عنيفة. ومن ناحية أخرى، إذا تولى المشروع تحالفاً يضم دولاً معرضة لآثار مناخية شديدة، ودعا دولاً أخرى إلى الانضمام إليه وتطوير هيكلية إدارية مشتركة، فقد تعرب دول عديدة عن معارضتها العلنية للمشروع، لكنها ستكون مسرورة في سرها بأن الهندسة المناخية قللت من مخاطر المناخ.
توصف طريقة ساي في بعض الأحيان بأنها مجرد سيناريو اجتماعي-تقني وهمي ينتمي إلى مستقبل بعيد قائم على الخيال العلمي. لكن من الممكن تقنياً إطلاق مشاريع محدودة من النوع الذي وصفناه هنا خلال خمسة أعوام. من الممكن لإحدى الدول أو لائتلاف من الدول الراغبة في إجراء اختبارات جادة للنواحي العلمية والسياسية لتطبيق الهندسة المناخية الشمسية أن تفكر في اللجوء إلى المشاريع المحدودة أو التجريبية عندما تصبح المخاطر المناخية بارزة بصورة أكبر.
اقرأ أيضاً: ما تبعات إيقاف جميع محطات الطاقة النووية في ألمانيا على الأهداف المناخية؟
نحن لا ندعو إلى مثل هذا الإجراء. في الواقع، نحن نكرر دعمنا لتعليق تطبيق هذا العمل مؤقتاً حتى تنال الأسس العلمية الموافقة الدولية وتخضع لتقييم نقدي، وحتى توضع آلية للحوكمة بصورة مُتَّفق عليها على نطاق واسع. غير أنه لا يمكن بناء تصور جيد للترابط القائم بين التكنولوجيا والسياسة في طريقة ساي بسبب الفكرة التي تقول إن هذا العمل يجب أن يبدأ بمشروع كبير يؤدي إلى إبطاء الاحترار على نحو ملحوظ، بل وحتى عكسه. يبيّن المثال الذي أوضحناه هنا أن عوائق البنية التحتية التي تقف أمام تطبيق الهندسة المناخية الشمسية أقل صعوبة من التصور الشائع. ويجب على صُنّاع السياسات أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار، وفي وقت قريب، عندما يدرسون كيفية تطوير الهندسة المناخية الشمسية بما يخدم الصالح العام، وضوابط الأمان اللازمة للتحكم فيها.