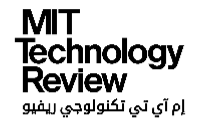في عام 2008، نشرت المملكة المتحدة أول سجل وطني للمخاطر، مما سمح للجمهور بإدراك أولويات الأمن الوطني في حالات الطوارئ المدنية. وقام التقرير بقياس المخاطر وفقاً لبُعدين، هما: التأثير النسبي والاحتمال النسبي، وكانت إمكانية تأثير وباء على رأس قائمة المخاطر. وبعد عام من ذلك، شهد العالم تفشي وباء أنفلونزا الخنازير الذي تسبَّب في مئات الآلاف من الوفيات. وفي حين سجلت المملكة المتحدة مئات الآلاف من الإصابات، إلا أن عدد الوفيات كان قليلاً نسبياً.
ورغم أن الأوبئة لا تمثل أحداثاً نادرة من منظور الحكومات، غير أن المسألة لا تكمن في قدرة بلد ما على استشراف تفشي وباء والاستعداد له تبعاً لذلك، بل يتعلق الأمر بقدرة الأنظمة القائمة على مواصلة عملها تحت مستوى الضغط الناجم عن الوباء، بغض النظر عن المعرفة المسبقة بإمكانية حدوثه. وفي هذا الصدد، شكَّل فيروس كورونا اختباراً للعمل تحت الضغط، ليس لأنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم فحسب، وإنما للعولمة بحدّ ذاتها.
لا شكّ أن الحقبة الحديثة من الاتصال الشامل المدفوع بالعولمة قد أدت إلى تعاظم خطر الأوبئة؛ حيث يرتفع احتمال انتشارها نظراً لزيادة تنقلاتنا. لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نحمِّل العولمة وحدها كامل المسؤولية في ذلك، وإنما ينبغي علينا الاستفادة من الاتصال المتأصل لسلاسل القيمة الموزعة عالمياً لتحسين طريقة تنبؤ البلدان بالأوبئة والكوارث وكيفية استجابتها، وتطوير التنسيق فيما بينها لمواجهة هذه المخاطر. كما ينبغي أن يصبح الاتصال وسيلةً لبناء القدرات اللازمة لتلبية الطموحات بتهيئة حلول أفضل لهذا النوع من المشاكل، التي من المرجح أن نواجهها بشكل متزايد في المستقبل.
وفي سياق الوباء الحالي، عندما نأتي على ذكر الطاقة الاستيعابية فإننا لا نشير إلى عدد الأسرّة وأجهزة التنفس الصناعي وعدد الموظفين والكمامات فحسب، وإنما نقصد أيضاً النماذج التنظيمية الكامنة وراء كيفية تخطيط المستشفيات والموردين لتأمين الإمداد المستمر مع الحفاظ على السلامة في نفس الوقت. إن الطاقة الاستيعابية هي بالفعل مسألة منهجية؛ وفي هذا الشأن -وعلى الرغم من الجهود البطولية على خطوط المواجهة الأمامية- كشف وباء كوفيد-19 عن وجود ضعف في التخطيط، كما ظهرت مخاوف متزايدة إزاء الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها بنية تحتية تعاني من قصور في الاستثمار إلى مشاكل اجتماعية مستشرية أكثر خطورة. فربما تؤدي هذه المشاكل إلى تفاقم التفاوتات القديمة والجديدة، مما قد لا يشكل تهديداً لنسيجٍ اجتماعي موزع على نحو غير متساوٍ فحسب، وإنما يسبب ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالعدوى والوفيات نتيجة كون مرافق الرعاية الصحية دون المستوى الأمثل وسيئة التنسيق.
وبينما تسعى الحكومات والمنظمات إلى تعزيز القدرات التي تحتاجها أنظمة السلامة والرعاية الصحية الوطنية -محاولة في الوقت نفسه التعامل مع مسألة التبعات الاجتماعية والاقتصادية- فإنها تلجأ بشكل متزايد إلى حلول تتسم بكثافة اعتمادها على البيانات حتى تتمكن من حرق المراحل لتوظيف وسائل استجابة أسرع وأكثر قابلية للتوسع: بدءاً من مبادرات التتبع والتعقب المستندة إلى بيانات تحديد الموقع الجغرافي في كوريا الجنوبية وفيتنام والصين وسنغافورة وغيرها، إلى الوسيلة واسعة الشهرة التي وظّفتها شركة علي بابا لاكتشاف الإصابة بكوفيد-19 والمبنية على الذكاء الاصطناعي، إلى نهج مجموعة بيانات كوفيد-19 المقروءة آلياً في الولايات المتحدة، إلى استعانة خدمات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة بكبار مزودي التكنولوجيا من أجل تصميم لوحة معلومات للاستجابة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى العشرات من الوسائل الأخرى.
ينبغي على الجمهور الأوسع الآن أن يتساءل عما إذا كان هذا السلوك الحكومي المستند بكثافة إلى البيانات يتعارض في جوهره مع الخصوصية، هل هناك تعارض فعلاً؟
يتضح الخيط الرفيع هنا عند النظر إلى استخدام كوريا الجنوبية للمعلومات الدقيقة المستندة إلى الموقع الجغرافي؛ حيث سيصبح هذا الاستخدام بلا ريب موضع دراسة مستقبلية، وسيغدو مرجعاً في موجة جديدة من أساليب الصحة العامة القائمة على الدقة الفائقة. وتنطوي المبادرات المماثلة على بعض المخاوف؛ لأن هذا النوع من النزعات التوسعية قد يؤدي إلى فرض وضع طبيعي جديد. وعلى الرغم من تفاقم مشكلة الخصوصية إزاء مساعي الاعتماد المكثف على البيانات -والتي تتجسد في تكثيف الحكومات في جميع أنحاء العالم لعمليات المراقبة وتوسيع نطاقات جمع البيانات- إلا أن هناك حاجة ماسة بالقدر نفسه لفهم مسألتين: الأولى هي كيفية تقييم البيانات لاحقاً وأسلوب قياسها، والثانية هي طريقة استخدام البيانات في إعداد قدرات القطاع العام لمواجهة الأزمات الجديدة المقبلة. ويمكن أن يساعد تناول هذين السؤالين معاً الإدارات على الانتقال إلى استخدام جيل جديد من الأدوات الفعالة للحكومة الرقمية، التي تستطيع التعلم والاستجابة بشكل مناسب لحالات عدم اليقين، وبما يتجاوز قدرات النماذج التقليدية للتنبؤات.
إذن، هل يمكن تلبية هذه الحاجة إلى بناء قدرات جديدة من خلال واجهات الذكاء الاصطناعي؟
لا تقتصر المسألة على إمكانية نجاح الذكاء الاصطناعي من عدمه، وإنما على إمكانية نجاحه في تأدية المهمة عندما نكون في أمس الحاجة إليه. وبكلمات أخرى، يكمن التساؤل في احتمال أن يؤدي الاعتماد على هذا النوع من الحلول إلى إدخال تحيزات وانتهاكات غير مقصودة للخصوصية، أو فيما إذا كانت البيانات المعالَجة المفترضة قادرة على التعامل مع أوضاع تتسم بهذه الدرجة من عدم اليقين. ففي أثناء الأزمات، تنزع الأخطاء إلى التراكم؛ بدءاً من الإجراءات الإدارية غير المتسقة، إلى الانتهاك السريع للخصوصية، إلى السلوكيات المخادعة التي تؤدي عن غير قصد إلى انتهاكات مستقبلية، ويؤدي كلٌّ منها إلى تفاقم التهديد المحتمل بتعميق خطر استشراء الأزمة بشكلٍ غير مُتعمَّد.
في الحقيقة، عند التعامل مع الظواهر المعقدة وغير الخطية، هناك حدٌّ وظيفي لقيمة الاستثمارات في تحسين دقة المعلومات. ويتم رسم هذا الحد من خلال موثوقية القدرة المؤسساتية على الاستجابة ليس للمتغيرات المعروفة فقط، وإنما الاستجابة خصوصاً لتلك التباينات التي تبدو متوقفة على طبيعة الأزمات والأحداث الكبرى. في الواقع، لا يكمن مربط الفرس في التهافت للحصول على أفضل المعلومات، وإنما في السعي من أجل الوصول إلى أفضل نظام يستطيع العمل بشكل مستقل عن تلك المعلومات نظراً لتمتعه بالقدرة على التكيف والتعلم. إن الحكومات والمنظمات التي ستُظهر أفضل استخدام للخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي لن تكون بالضبط تلك التي تمتلك أفضل تحليلات للبيانات، بل هي تلك التي تستخدم هذه التحليلات لتحسين القدرة على الاستجابة تجاه العوامل المتطرفة غير المألوفة والمؤثرات الخارجية غير المتوقعة، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى فهم نمط مختلف لاستخدام الذكاء الاصطناعي ونشره؛ لأن الإمكانات الواعدة التي يحملها لا تنحصر فقط في أمثَلة الأصول الموجودة.
يحتاج العالم إلى إطلاق نقاش جديد حول شكل الأطر التوسعية الناظمة لخصوصية وموافقة الجمهور التي تتيح تنمية القدرات الشاملة، وحول كيفية بنائها على وجه السرعة، أو أسلوب إعدادها لمواجهة الأزمة الحتمية القادمة، وكيفية إنشاء الاستجابة الضرورية الطارئة للصحة العامة التي افتقرنا إليها بشدة خلال الوباء الحالي. وفي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بطريقة استجابتنا حالياً فقط، بل يرتبط أيضاً بكيفية بناء البنية التحتية التي يمكننا إضفاء الطابع المؤسساتي عليها من خلال التوظيف المُمنهَج لخدمات الذكاء الاصطناعي في بناء نظام مضاد للهشاشة من الغد فصاعداً.