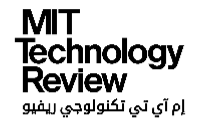انتابني الشعور بالذعر من فيروس كورونا لأول مرة في وقت مبكر من صباح أحد الأيام في يناير. حين وصلتني رسالة بالبريد الإلكتروني معنونة بأنها معلومات مهمة يرجى قراءتها، موجهة من مدرسة ابني الابتدائية، قبل دقائق فقط من الموعد الذي نضعه فيه على متن الحافلة. فقد تعرض والدا أحد معلميه -كانا قد عادا تواً من الصين- للإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تبين في الواقع أنهما الحالتان رقم 8 ورقم 9 اللتان تم تسجيلهما في سنغافورة، وأُخضِع المعلم المذكور للحجر الصحي.
كانت سنغافورة من بين أوائل الدول التي عانت من تفشي وباء كورونا. في الأشهر التي أعقبت ذلك، كان مطمئناً ومثيراً للقلق في الوقت نفسه مشاهدة رحلة تحولها من بؤرة مبكرة للتفشي إلى بلد ينعم بشيء من الأمان، صامدٍ بكل عزيمة في وجه كائن غازٍ تسلل إلى أجسام الكثير من الأشخاص.
تركزت التعليقات الأولية للدول الغربية على إخفاقات النظام الأوتوقراطي في الصين، الذي أخفى شدة تفشي الوباء في ووهان، وهو ما نعرفه الآن بأنه تكلفة كارثية. كلما ازداد انتشار الوباء، أصبح من الواضح أكثر أن الدول الديمقراطية الليبرالية الغربية أساءت معاملته بشدة أيضاً، وانتهى الأمر بحدوث تفشيات شديدة ربما كان من الممكن تجنبها.
ومع ذلك، فمن غير المنطقي أن ننظر إلى فيروس كورونا على أنه نوع من اختبار حيوية كلا الأنظمة الليبرالية والاستبدادية. بل علينا بدلا ًمن ذلك أن نتعلم من الدول التي استجابت بشكل أكثر فعالية، ألا وهي الدول الديمقراطية المتقدمة ذات الحكم التكنوقراطي في قارة آسيا، وهي المجموعة التي كانت تُعرف يوماً باسم "النمور الآسيوية". في الدول الغربية، كشف فيروس كورونا عن خدمات عامة مليئة بمواطن الخلل، وانقسامات سياسية. لكن هونغ كونغ وكوريا الجنوبية قد أبلتا في إدارة الوباء على نحو أفضل، في حين تمكنت كل سنغافورة وتايوان من إبقاء المرض تحت السيطرة بشكل شبه تام، في الوقت الحالي على الأقل.
الدروس المستفادة
يُظهر هذا الأمر بشكل جزئي فوائد الخبرة؛ فقد عانت جميع "التكنوقراطيات" الآسيوية -كما يصفها المفكر الجيوسياسي باراغ خانا- من تفشي وباء سارس ابتداءً من العام 2002، بالإضافة إلى مخاوف بسيطة أحدث عهداً، مثل إتش-ون-إن-ون (H1N1) عام 2009. هذه الخبرات، التي كانت مؤلمة في ذلك الوقت، ساعدت المخططين الحكوميين على التفكير خلال حالات الطوارئ، ووضع خطط لإدارة التفشي وتخزين السلع الأساسية. جمعت تايوان الملايين من الكمامات الجراحية، والمآزر، وكمامات إن-95 للعاملين في المجال الطبي، واحتفظت بكميات إضافية من هذه الأشياء تقدر بعشرات الملايين لعامة الناس.

"نتيجة اختبارك إيجابية. ستصل سيارة الإسعاف إلى هناك في غضون 20 دقيقة. احزم أغراضك".

ويعود الفضل جزئياً أيضاً إلى فيروس سارس الذي أدركت الدول الآسيوية حاجتها إلى التحرك السريع في مواجهته، كما أشار ليو يي سين، رئيس المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة، في أوئل يناير. في تلك الفترة، كان لايزال كوفيد-19 يُشار له على أنه "التهاب رئوي غامض".

في مختلف أنحاء المنطقة، تم إجراء فحص إلزامي لدرجات الحرارة لدى المسافرين على متن الرحلات الجوية القادمة من المناطق المتضررة من الصين. ومع تفاقم الأزمة، تم إلغاء تلك الرحلات الجوية، ثم بعد ذلك تم إغلاق الحدود بالكامل. لم تتبع جميع البلدان نفس النموذج من الاستجابة تماماً: فهونغ كونغ واليابان أغلقتا المدارس فيهما في مرحلة مبكرة، في حين بقيت المدارس مفتوحة في سنغافورة. ولكن جميع هذه البلدان تصرفت بشكل سريع، في إطار استجابات منسقة بقيادة مجموعات من الخبراء.
كما كان هناك مراكز جديدة للعلاج أيضاً، بما في ذلك المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة، وهو منشأة تضم 330 سريراً افتُتح العام الماضي، ويقع على بعد 10 دقائق من مكتبي بالسيارة. كان لزاماً على أحد أصدقائي البقاء في سنغافورة لأسابيع خلال شهر مارس، حيث كان الحالة رقم 113 التي سُجلت فيها، وقد أصيب بالفيروس خلال رحلته إلى أوروبا، وبدأ يشعر بالأعراض أثناء رحلة عودته إلى الديار. تم نقله في البداية إلى مركز الأمراض المعدية لإجراء اختبار -"كان المشهد يشبه كثيراً ما نراه بعد وقوع كارثة رهيبة، حيث الكل يرتدي بدلات بلاستيكية مع نظارات وأقنعة واقية كبيرة، داخل غرف تعج بالحواجز البلاستيكية"- ولكن تم إرساله إلى المنزل ليبقى معزولاً وينتظر النتائج. ثم تلقى مكالمة بعد مضي بضع ساعات. يتذكر قائلاً، بينما يقضي عزلته في المركز في أواخر مارس: "قالوا لي: نتيجة اختبارك إيجابية. ستصل إليك سيارة الإسعاف في غضون 20 دقيقة. احزم أغراضك".
لعبت التكنولوجيا دوراً مهماً أيضاً؛ فقد لجأت الصين إلى المراقبة المكثفة والمُستبيحة للخصوصية للسيطرة على انتشار الفيروس، مما دفع عمالقة التكنولوجيا لتتبع ومراقبة مئات الملايين من المواطنين. انتشرت تطبيقات جديدة، لا سيما التطبيق المسمى "أليباي هيلث كود"، الذي منح المستخدمين تصنيفاً لونياً يتضمن الأخضر أو الأصفر أو الأحمر، بناءً على سجلاتهم الصحية الشخصية الموجودة في حوزة الشركة. في الواقع، فإن التطبيق -الذي شارك المعلومات مع الشرطة الصينية وغيرها من السلطات العامة- هو الذي حدد مَن تم عزله في منزله، ومَن ليس كذلك.
اتخذت الدول الديمقراطية الآسيوية طرقاً أكثر بساطة؛ حيث لجأت إلى مراقبة التفشي وإدارته باستخدام أدوات لا تتعدى الهواتف، والخرائط وقواعد البيانات. قامت سنغافورة على وجه الخصوص بتطبيق نظام تتبع لجهات الاتصال مثير للإعجاب، حيث قامت فرق مركزية من موظفي الخدمة المدنية بتعقب الأشخاص الذي يُحتمل إصابتهم بالعدوى والتواصل معهم. قد تكون مكالماتهم صادمة، ففي لحظة تكون في غفلة من أمرك أثناء عملك، وفي اللحظة التالية تتلقى مكالمة هاتفية من وزارة الصحة لتبلغك بلطف أنك ركبت سيارة أجرة قبل بضعة أيام رفقة سائق مرض في وقت لاحق، أو أنك كنت جالساً بالقرب من شخص مصاب بالعدوى أثناء تناولكما العشاء في أحد المطعم. أي شخص يتلقى مثل هذه المكالمة، يتلقى تعليمات صارمة بالانطلاق بسرعة نحو المنزل وعزل نفسه ذاتياً.
الذي جعل هذا ممكناً، هو أن أي شخص تعرض للإصابة كان يواجه إمكانية الاستجواب لمدة ساعات. قال لي صديقي: "أجلسوني واستجوبوني حول رحلتي: عن كل يوم فيها، وحتى عن كل دقيقة قضيتها فيها". ما الأماكن التي ذهبت إليها؟ وما سيارات الأجرة التي ركبتها؟ ومن الأشخاص الذين رافقتهم؟ وكم قضيت من الوقت مع كل واحد منهم؟ كانت عملية التعقب والتتبع شاقة، لكنها أسفرت عن نتائج رائعة. نصف الأشخاص الذين أصيبوا في سنغافورة، والذين يبلغ عددهم نحو 250 شخصاً بحلول منتصف مارس، علموا أول مرة بأنهم معرضون لخطر الإصابة عندما اتصل بهم أحد الأشخاص من الحكومة وأبلغهم بذلك.
أظهر نظام الاختبار في كوريا الجنوبية كفاءة مماثلة، حيث أجبر الشركات الطبية المحلية على العمل معاً لتطوير مجموعات جديدة تم طرحها بصورة نشطة جداً، مما سمح للمخططين بتتبع انتشار الوباء. وبحلول أواخر مارس، كانت كوريا الجنوبية قد أجرت الاختبارات لنحو 300,000 شخص، أي ما يقرب من عدد الأشخاص الذين تمكنت الولايات المتحدة من اختبارهم في ذلك الوقت، ولكن عدد سكان كوريا الجنوبية يبلغ سدس عدد سكان الولايات المتحدة.
الوضوح في نقل المعلومات
شكلت الشفافية عاملاً آخر، على الرغم من أنها ربما تكون أقل توقعاً في المجتمعات الآسيوية الأكثر استبدادية. صحيح أن التغطية الإعلامية في المراحل الأولى من تفشي الوباء كانت أكثر تكتماً واحتراماً في دول مثل اليابان وسنغافورة عنها في أماكن مثل المملكة المتحدة؛ حيث سلطت التقارير الجريئة الضوء على جميع أنواع التفاصيل التي ربما تفضل السلطات العامة التقليل من شأنها، مثل خطط الطوارئ لفتح مشرحة في هايد بارك في لندن.
ومع ذلك، تميز التواصل المنفتح والصريح من قِبل الحكومات بنمط ثابت في استجابات الدول الآسيوية الأكثر نجاحاً. وضعت سنغافورة إعلانات بارزة على الصفحات الأولى في وسائل الإعلام، بما في ذلك الحملات الأولى لمحاولة منع المواطنين الذين لا يعانون من أعراض المرض من شراء الكمامات الجراحية، والتسبب في نقص لأولئك الذين يحتاجون إليها. قدمت كل من تايوان وكوريا الجنوبية بيانات موثوقة ومفتوحة لمواطنيها، إلى جانب الإحاطات الإعلامية المنتظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع تفاقم انتشار الوباء، قمت برحلة إلى الولايات المتحدة، التي كان من المؤكد أنها آخر بلد سيصلها المرض ولو لبعض الوقت، حيث غادرت من بين حشود فحص درجات الحرارة وأجهزة مسح حرارة الجسم التي كانت مصطفة في ذلك الوقت على طول ممرات مطار شانغي.
خلال الأسبوع الذي ابتعدت فيه، تلقيت معلومات واقعية مستجدة من دون ضجيج، تم إرسالها إلى هاتفي الذكي لنحو 3 مرات في اليوم الواحد من قِبل الحكومة السنغافورية عبر واتساب، تتضمن تفاصيل حول الإصابات الجديدة وما الذي كانت تفعله السلطات استجابةً منها.
هذا التركيز على المعلومات الصريحة كان درساً آخر مستفاداً من الأزمات السابقة. فخلال أزمة سارس، وكذلك تفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) عام 2015، تم انتقاد الحكومات في دول مثل كوريا الجنوبية لإخفائها المعلومات والإضرار بثقة العامة. هذه المرة، يبدو أنهم استنتجوا أن نشر المستجدات بشكل متكرر من قِبل السياسيين وخبراء الصحة، شكَّل تقنية أكثر فعالية في وجه تضليل المعلومات المتعلقة بالفيروس.
هذا لا يعني التظاهر بأن كل شيء كان مثالياً؛ فقد ارتكبت اليابان خطأ في استجابتها لوصول سفينة أميرة الماس السياحية إلى ميناء يوكوهاما، وواجهت -مثل الولايات المتحدة- أسئلة ملحَّة منذ ذلك الحين حول افتقارها لمعدات الاختبار الخاصة بها.
من جهتها، تعرضت حكومة هونغ كونغ لانتقادات واسعة النطاق أيضاً، في أعقاب احتجاجات الشوارع الأخيرة التي قوضت ثقة عامة الناس بشدة. ومع ذلك، فقد أظهر مواطنو هونغ كونغ إرادة استثنائية للعزل الذاتي، الذي قد يعود جزئياً إلى ارتيابهم بشأن قدرة البلاد على حل الأزمة، وليس لأنه كان إذعاناً منهم لأوامر الحكومة.
في الواقع، فإن هونغ كونغ وتايوان، هما في حد ذاتهما أمثلة عن ديمقراطيات مشاكسة، تكذب فكرة أن الدول الآسيوية قد نجحت في هذه الأزمة لأن مواطنيها يفعلون ما يطلب منهم مقارنة بمواطني إيطاليا أو أميركا الشمالية أصحاب النزعة إلى الحرية.
هذه الفكرة لها أصداء غير مريحة للنقاش العنصري القديم حول ما يسمى بالثقافات "الكونفوشيوسية"، التي وصفها مفكرون مثل العالم السياسي الأميركي صمويل هنتنغتون بأنها هرمية، ومنظمة، وتميل إلى تقدير الانسجام على حساب المنافسة. فعند الحديث عن "الأنفلونزا الصينية"، أو التفشي المفاجئ لرهاب الصين (أو الصينوفوبيا) على نواصي الشوارع الأميركية، فإن هذا النمط من التفكير يفسر لنا قليلاً الأداء الجيد لبعض البلدان، والأداء السيئ للبعض الآخر.
الاستعداد عامل نجاح رئيسي
في أكتوبر الماضي، أصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية تقريراً مطولاً يتضمن تصنيفاً للدول وفق مؤشر الاستعداد العالمي للأوبئة. حلت الولايات المتحدة في المركز الأول، تليها بريطانيا وهولندا، في حين حلت اليابان وسنغافورة في المركزين الواحد والعشرين والرابع والعشرين على الترتيب. وبالرغم من أن جدول التصنيف هذا قد خضع لمرحلة إعداد خاصة به، إلا أنه أثبت خطأه تماماً كما يبدو.
فقد قدمت آسيا العديد من الأمثلة على السياسات الناجحة، ابتداءً من بناء المستشفيات السريع في الصين، مروراً بالاختبارات المعمقة في كوريا الجنوبية، وصولاً إلى تتبع الاختلاط بين الناس ونقل المعلومات الصريحة لعامة الناس في سنغافورة؛ في حين أن ما حدث في الدول الغربية، هو أن الحكومات التي بدا أنها مهيأة بشكل جيد لإظهار استجابة سريعة، تبين أنها قاصرة وضعيفة.

تجاهلت الاقتصادات الليبرالية الغربية نمط القدرات الذي يمكن للدولة أن تتمتع به في قطاع الصحة العامة والاستعداد للأوبئة، والذي كانت تبنيه الدول الآسيوية بصمت طوال السنوات الماضية.

كان الخيط الذي يوحد البلدان التي أبلت بلاءً حسناً، هو أنها -سواء كانت ديمقراطية أم لا، فقد كانت دولاً قوية- قادرة على تطبيق النهج التكنوقراطي في إدارة البلاد، دون أن تعوقها الانقسامات الحزبية إلى حد كبير. لقد كانت الصحة العامة هي من تقود السياسة، وليس العكس.

من المرجح أن تتكشّف حقيقة هذا الأمر بصورة قاسية مع انتشار الفيروس في أماكن أخرى من آسيا، خاصة في أماكن مثل الهند، وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، حيث تتسم قدرات الدول بالضعف بشكل ملحوظ.
حاولت العديد من هذه البلدان تأمين سكانها، كما فعلت الاقتصادات المتقدمة من قِبلها. ولكن حتى لو تمكنت من إبطاء سرعة انتشار الفيروس، فهي غير قادرة على الاستفادة من وجود أنظمة صحية قوية، ناهيك عن نوع الاختبار، وأنظمة تتبع الاختلاط بين الناس التي حافظت على أمان أجزاء كثيرة من آسيا.
قد لا تستمر هذه الأفضلية الآسيوية في الكفاءة في المراحل المقبلة من أزمة كوفيد-19، حيث يتحول التركيز إلى إدارة ركد اقتصادي كبير، وهو مجال تتمتع فيه العديد من الحكومات الغربية بخبرة حديثة العهد في أعقاب الانهيار الذي حدث عام 2008. وقد كشفت حكومات مثل بريطانيا والولايات المتحدة بالفعل عن برامج تحفيزية كبيرة. ولكن لا يمكن إنكار أنه عندما كانت تكافح من أجل التعافي من تلك الأزمة المالية، تجاهلت الاقتصادات الليبرالية الغربية نمط قدرات الدولة في مجالات مثل الصحة العامة والاستعداد للأوبئة، التي كانت تبنيها الدول الآسيوية بصمت. ظهر فيروس كورونا ليكون بمنزلة اختبار حقيقي، وما يفترض بأنها الدول الأكثر تقدماً في العالم، قد فشلت جميعها في مواجهته بشكل واضح للغاية.
كل هذا يضر بالسمعة العالمية للولايات المتحدة على وجه الخصوص؛ ففي عام 2014، تمكنت إدارة أوباما من قيادة جهود الاستجابة العالمية لتفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا. والآن، وبعد 6 سنوات من ذلك التاريخ، بالكاد يظهر دونالد ترامب قادراً على تنظيم سبل الاستجابة داخل بلاده.
وقد بدأت الصين باستثمار هذه الحقيقة لكي تشير إلى تفوق نموذجها الاستبدادي في الحكم.
سيكون هذا درساً سيئاً يمكن استخلاصه مما يجري. ما يهم بدلاً من ذلك، هو ظهور انقسام جديد بين نوعين من الدول: الدول القادرة على التخطيط على المدى الطويل، والتصرف بحزم، والاستثمار من أجل المستقبل، والدول غير القادرة على كل ما سبق.