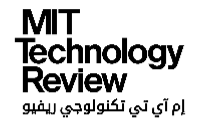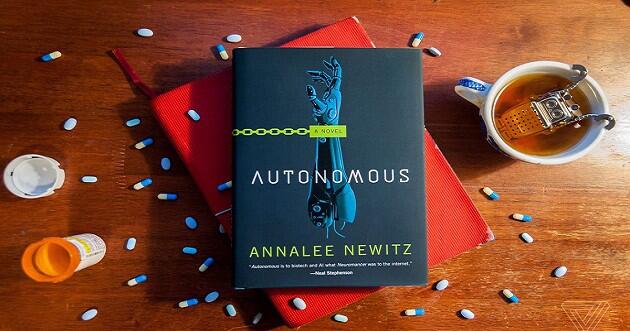لديّ إيمان راسخ بأن محور أدب الخيال العلمي هو الحاضر وليس المستقبل. ولكن عندما بدأت في كتابة روايتي الأولى، "أوتونوماس"، قضيت الكثير من الوقت في أتون المعاناة متسائلة كيف يمكنني تصوير القرن الثاني والعشرين بحيث تعيش فيه شخصياتي الروائية بشكل معقول قابل للتصديق.
لم أتوهّم مطلقاً أنني كنت أشارك في نبوءة ما، ولكنّي أردت أن يشعر القراء بأنّ ما أقدمه لهم يشكل مستقبلاً يمكن أن ينبثق واقعياً من التقنيات والمشاكل الاجتماعية الحالية.
تشرح مؤلفة رواية أوتونوماس أنالي نيويتز كيف مضت في بناء عالمها عام 2144
تدور أحداث الكتاب في المستقبل، في زمن تفصلنا عنه حوالي 125 عاماً، دون حصول أي نهاية مدمّرة للعالم تعيد رسم مسار التاريخ، لم أرغب في رسم مستقبل يهزأ من المسار الطبيعي لتطور الأمور في واقع الأمر.
لذا كان أول شيء فعلته - فقط للحصول على منظور مناسب للأمور - هو التفكير في كيفية استمرار عدد من الأفكار والاتجاهات التي يعود عمرها إلى 125 سنة في محافظتها على الارتباط بواقعنا حتى وقتنا الراهن.
ولقد فوجئت للكمّ الهائل من الأشياء التي لم يطرأ عليها أيّ تغيير: إذْ ما تزال نقاشاتنا تدور حول نظرية النشوء والتطور، وما نزال نركب القطارات ونلتقط الصور، وما يزال لدينا حالاتُ تمرّدٍ راديكالي للشباب في تركيزهم على حرية الحب، والتكنولوجيا الغريبة، والنظرية النباتية.
كما أنّ العديد من الأشياء الصغيرة ما تزال محافظة على وجودها أيضاً، مثل حقيقة أنّ الناس في منتصف القرن التاسع عشر كانوا يقرؤون مجلة "أتلانتيك" ويخيّمون في وادي يوسيمايت ،كانت رغبتي تدور أساساً حول تقديم شخصياتي عام 2144 بنفس الغرابة (أو ربما أقلّ من) التي يمكن أن أراها في جيل جدّ جدّ جدي.
وبينما كنت أكتب الفصول الأولى، قررتُ أنّه لا بدّ أن يستمر الناس في هوسهم بالبحث في جوجل للحصول على معلومات عن الممارسات الجنسية الغريبة على شبكة الإنترنت، كما أنهم سيواصلون بالطبع في تدخين الحشيش.
وستبقى الشركات تلاحق الأشخاص قانونياً بسبب جرائم الملكية الفكرية، بل سيكون لدينا قوانين أكثر بكثير تتعلق ببراءات الاختراع إلى الحد المثير للسخرية.
أردت أيضاً أن أضع يدي على عشوائية ما سيبقى في المستقبل، لذلك جعلت بعض الشخصيات تزور "مركز أبردين" في فانكوفر، إذ في بعض الأحيان يصبح مركز التسوّق مبنىً تاريخياً في حين يلقي النسيانُ بظلاله على ما يسمى "الآثار العظيمة" خلال جيل واحد من الزمان.
وبمجرد أن وضعتُ يدي على الاستمرارية التاريخية التي سأرسم روايتي ضمن إطارها، كان علي أن أقرّر ما التغيير الذي سيطرأ عليه.
لقد وضعتُ بالفعل جدولاً زمنياً، قمت بتنقيحه عدة مرات خلال تقدّم عملي في الرواية، حيث حددت جميع التغييرات التاريخية الكبرى من الآن ولغاية عام 2144. إذ ستنهار الأمم وتحل محلها تحالفات اقتصادية فضفاضة.
وسيصل الذكاء الاصطناعي إلى درجة شبه بشرية في امتلاك الإحساس. وستجتاح حركة نسوية المنطقة العربية. كما ستلغي مدنُ المغرب العربي جميع اللوائح التي تحدّ من التكنولوجيا الحيوية، لجذب الشركات الغنيّة إلى المنطقة.
كما ستصبح عبودية أعمال السخرة حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي حوالي عام 2070. ومن المفارقات حدوث هذا سيكون بعد حصول الرجال الآليين على حقوق تكافئ الحقوق البشرية مع بعض الاستثناءات. إذ سيتمكّن الرجال الآليون من التحرّر من صانعيهم بعد العمل لديهم لمدة لا تتجاوز 10 سنوات تكفي لتسديد كلفة بنائهم. ولكن سيؤدي هذا الأمر إلى خلق مسألة قانونية مثيرة للاهتمام، وخاصة إذا كنتَ شركة تريد استخدام بعض العمالة البشرية في أعمال السخرة. فإذا كان من الجائز استعباد رجل آلي شبيه بالإنسان، فلماذا لا يمكن استعباد الإنسان ذاته؟ وتخيّلت دعاوى قضائية تنصّ على "حق الإنسان" في أن يتم استعباده في مختلف المناطق الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
بالكاد نلمح هذه الخلفية الدرامية في "رواية أوتونوماس"، ولكنّي أردت أن تكون هذه الأحداث واضحة تماماً في ذهني حتى أفهم الإطار الذي تتصرف شخصياتي ضمنه. وأشدّد هنا مرة أخرى على أني لم أكن أنظر إلى ما أكتبه كنوع من النبوءة. لقد شاركت في تمارين الاستشراف المستقبلي مع مجموعات مثل معهد المستقبل، وبالنسبة لهم كانت السمة المميزة "للتوقعات" الجيدة هي أنها يجب أن تشمل مجموعة من النتائج المحتملة. لقد كنت أحاول اختراق مسار واحد فقط من خلال غابةٍ من الاحتمالات الممكنة لرسم المستقبل.
كان جدولي الزمني إلى حد كبير محاولةً تفصيلية لتبرير القصة التي أردت كتابتها. عندما شرعتُ في كتابة "أوتونوماس"، كنت على يقين من بعض الأشياء التي أريد أن أضعها في إطار المستقبل الذي أرسمه. إذ لا بدّ من وجود ذكاء اصطناعي يكافئ الذكاء البشري عندئذ لأنّ إحدى شخصيات الرواية الرئيسية هو روبوت قادر على الإحساس. كما أنه لا بد من وجود عبودية. وسيكون هناك قراصنة، بسبب نظام الملكية الفكرية المذكور آنفاً.
أعتقد أنه لن يرفّ جفن الكثير من القراء لفكرة أن يكون لدينا رجال آليون يمتلكون إحساساً بعد 125 عاماً ولكن لا بدّ أن يتملكهم الاستغراب حقاً من أن يعاني الكثير من الناس من الاستعباد. ولكنني أتابع أبحاث الذكاء الاصطناعي في حياتي اليومية لكوني صحفية، ولذا لديّ شكّ كبير يقارب اليقين في احتمال حصولنا على شخصية تشبه هذا الروبوت الآلي في عالمنا في غضون العديد من القرون القادمة، على فرض وجود احتمال كهذا بالأصل. ومن ناحية أخرى، تبدو عودة الرّق من جديد أمراً واقعياً بشكل مثير للقلق. فبعد كل شيء، كان الرّق قانونياً في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 150 عاماً.
وما زالت آثاره ملموسة هنا بطريقة واضحة للعيان. أودّ أن أعتقد أننا نمضي نحو الإصلاحات ومنح الحقوق المدنية للجميع. ولكن من المرجّح أننا سنجد طريقة جديدة لتحويل بعضنا إلى عبيد.
ربما تمثّل الجزء الأكثر صعوبة في رسم عالمي المستقبلي في طرح التفاصيل الصغيرة، مثل التعبيرات الملطّفة التي يستخدمها الناس للإشارة إلى العبودية، أو كيفية ولوجهم الإنترنت. على الشخصيات أن تفعل أشياء بسيطة مثل تناول الطعام، وتشغيل أضواء الإنارة، واحتساء الكثير من الكحول في قضاء ليلة عطلة. لكن تؤدي هذه التفاصيل اليومية إلى أسئلة أكبر. ما مصدر طاقة الأنوار؟ تدور أحداث روايتي بعد الذروة النفطية، فهل تعمل الأنوار على الطاقة البديلة؟ البطاريات؟ هل الأنوار عبارة عن مجرد بكتيريا متوهجة تعيش على السقف؟ أيضاً، متى سوف تذهب شخصياتي إلى النادي؟ هل سيبقى لدينا مفهومُ عطلات نهاية الأسبوع في المستقبل؟ هل سيزور الأشخاص بعضهم في المساء غالباً، أم أنّ وارديات العمل ستكون عشوائية لدرجة تقبّل الذهاب إلى حفلة صاخبة عند الثانية بعد الظهر؟ وما الثياب التي سيرتديها الأطفال عند ذهابهم إلى هذه النوادي؟.
قررتُ أن الدروع الخفيفة ستكون أحد اتجاهات الموضة، لأن الصناعة النانوية ستؤدي إلى وفرة من المواد التي تبدو وكأنها من الحديد ولكنها خفيفة مثل الرغوة. ولكن من المهم الإشارة هنا إلى عدم رغبة قراء الأعمال الأدبية الخيالية في الاستفاضة في إعطاء الكثير من المعلومات عن خلفية كل مشهد لتوضيح سبب رغبة الأطفال في ارتداء الدرع وطلاء سقوف غرفهم بالبكتيريا المنيرة. فهم يريدون فقط رؤية المستقبل بكل غرابته المشرقة أو المهترئة أو السامة. أي أنهم يريدون تقديم غرائب المستقبل كمجرد أجزاء عادية تماماً من المشهد العام.
تعتبر شخصيات روايتي العديد من الأشياء كأمور مسلّم بها كأن تكون شوارعهم مصنوعة من الرغوة القابلة للتحلل، وأن تنتج الطابعاتُ ثلاثية الأبعاد أنسجة بيولوجية، وأن تقود الشاحنات نفسَها بشكل ذاتي، وأن تنتشر سلسلة شعبية من المقاهي التي تقدم البانوك في شمال كندا. ستكون المدن "ذكية"، مع البنى التحتية التي تثرثر مع نفسها باستخدام مبدّلات في الشبكة الغبارية، وهي شبكة من نقاط الوصول إلى الإنترنت يتم نثرها على شكل غبار في الهواء كل عام باستخدام الطائرات. لا يلعب أيّ من هذه التفاصيل دوراً مهماً في الحبكة، لكنها ببساطة توفّر شعوراً بالحياة اليومية عام 2144.
لكنني لم أكن خجولة أبداً في طرح الكثير من التفاصيل عندما تعلق الأمر بالحديث عن دماغ شخصية الرجل الآلي، "بالادين". إذ إني أردت أن يدرك القراء صعوبة معرفتك أنّ دماغك يشغّل برامج وضعها فيه شخص آخر - برامج تتحكم في الرغبة والتصرف وجميع الأشياء الأخرى التي نعتبر أنها تصنع منّا ما نحن عليه. لقد بذلت جهدي في إدراج أكبر قدر ممكن من التفاصيل قدر الإمكان حول كيفية تفكير "بالادين" وتواصله مع الآخرين، وتعلّمه من البيئة.
وبعد ذكر ما سبق، لا بدّ لي من القول إنني لم أجعل عقله "كدماغ يحتوي على وحدة معالجة مركزية قادرة على الإحساس" على النحو الذي يتوقعه مشجعو "ستار تريك" لأنني كنت أركّز على تجربة حصول الرجال الآليين على دماغ، وليس على بنيته. ومرة أخرى، تعتبر هذه إحدى السمات المميزة لكيفية رسم الخيال العلمي للمستقبل. فهو يغمر القارئ في تجربة ذاتية من أشكال المستقبل المحتملة، بدلاً من شرح كل التفاصيل الفنية لما يمكن أن يحدث.
كلما ازداد عمق صلاتنا بشخصياتنا الروائية، أصبح عالمها المستقبلي أكثر وضوحاً. لا يشير هذا إلى قدرة الشخصيات والحبكة على التعويض عن عالم رُسم اعتماداً على تصورات خاطئة غير متناسقة، أو غير قابلة للتصديق علمياً واجتماعياً. ومع ذلك، فوفقاً لتجربتي، إن أغلب العمل الذي يسهم في البناء الرائع لعالم جديد لا يجد طريقه إلى صفحات الكتب. إذْ لا يرى القرّاء أكثر من أسطح هذا العالم وحوافّه، بنفس الطريقة التي نرى بها عالمنا الحقيقي. وفي خضمّ هذه العملية، كما آمل، نصبح أكثر وعياً بكيفية ترابط أجزاء عالمنا الحالي ببعضها.