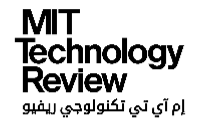في عام 2000، خضع رجل يُعرف فقط باسم السيد أوفت لتحقيق في سلوك غير مرغوب بدر منه وهو التحرش بالأطفال. في الواقع، لم يمض وقت طويل حتى تمت إدانته بسبب القيام بمخطط احتيالي. ولكن في اليوم الذي سبق الحكم عليه بعقوبة السجن، شعر كما لو أن رأسه على وشك الانفجار، وبعد إخضاعه إلى بعض صور الأشعة، وتبين أن لديه ورماً بحجم بيضة يختبئ في دماغه.
بدأت تلك الرغبة لديه بالتلاشي بعد إزالة الورم، وذلك وفقاً لدراسة حالة نشرتها الصحيفة العلمية الأميركية "جاما نورولوجي" (JAMA Neurology)، في عام 2003، إلّا أنها عاودت الظهور مجدداً بعد مرور عام واحد، وكشف مسح جديد لدماغه عن عودة الورم، وبعد أن تم استئصاله مرة أخرى، غادرته تلك الرغبات نهائياً.
تُلخص قصة السيد أوفت الحجة القائلة بأن "عقلي هو ما أرغمني على فعل هذا"، إنه دفاع عن النفس أطلقه مجرمون مدانون بجرائم قتل في العقود الأخيرة، من محاسبين خنقوا زوجاتهم إلى أشخاص مضطربين عقلياً هربوا من السجن. وقد استخدموا جميعهم صور أشعة تُثبت وجود تغيّرات غير طبيعية في المخ لديهم، أملاً في عقوبة مخففة. ولم يقتصر هذا على حالات تشوهات الدماغ، ففي عام 2009، حكمت محكمة إيطالية بعقوبة سجن مدتها سنة واحدة لصالح قاتل لأنه يحمل جينات مرتبطة بوجود نزعة عنيفة لديه.
أقل ما يمكننا قوله، هو أن إضفاء الصبغة الشرعية على مثل هذه الالتماسات بحجة "التركيبة البيولوجيا المعطوبة" مثيرة للجدل، ولكنها تثير جدالاً آخر، وربما احتمال مقلق: إذا كانت السلوكيات الغريبة في البيولوجيا قادرة على أن تكون بمنزلة دليل على البراءة، فعندئذ يمكن لهذه السلوكيات نفسها أن تستخدم في التنبؤ باحتمالية ارتكاب جريمة – حتى قبل ارتكابها؟
"التنبؤ البيولوجي" لمنع الجرائم
هذه هي الفكرة من وراء استخدام "التنبؤ البيولوجي" لرفع مستوى الجهود المبذولة في سبيل منع الجريمة. فإذا كان لديك مؤشر بيولوجي -بعض المؤشرات في دماغك أو جيناتك، على سبيل المثال- يرتبط ببعض التصرفات التي تجعلك أكثر عرضة لارتكاب جريمة، فإنه يمكننا أن نحاول اتخاذ إجراءات معينة لإبقائك مستقيماً.
على سبيل المثال، تخيل أن ابنك يحمل نوعاً معيناً من الجينات، وليكن "جين" (MAOA)، والذي يسمى مجازاً جين المحارب، إن هذا شيء غير ملحوظ بحد ذاته، ولكنه إذا كان قد تعرض للإيذاء خلال مرحلة طفولته، فهناك أدلة متزايدة على احتمال أن يصبح عنيفاً ومتهوراً أعلى بكثير من المتوسط. وبسبب ذلك، قد يشجع طبيب الأطفال على إخضاعه لعلاج نفسي وقائي، أو الاكتفاء بأن يتابعه مركز رعاية للأطفال التأكد من عدم تعرضه لسوء المعاملة.
ولكن يمكن أيضاً استخدام التنبؤ البيولوجي بطريقة أكثر مباشرة. افترض أنك سجين وتنتظر حصولك على إخلاء سبيل مشروط. تماشياً مع دراسة سابقة، يتم وضعك أمام شاشة يظهر عليها حرف X مرات متتالية، ولكن من حين لآخر يظهر الحرف K بدلاً منه، ويُطلب منك الضغط على زر عندما ترى الحرف X، وليس الحرف K. وبينما تفعل ذلك يتم مسح دماغك للبحث عن نمط سلوكي معين، وإذا كان دماغك يُظهر ذلك، فإنه يعتبر خبراً سيئاً لأنه يفيد بأن لديك ضعف احتمال ما لدى السجناء الآخرين لأن ترتكب جرماً آخر خلال 4 سنوات، وبالتالي لن تحصل على إخلاء سبيل مشروط.
كما هو الحال مع كل هذه التقنيات، من السهل رؤية كيف يمكن تسخير التنبؤ البيولوجي لتحقيق أهداف سياسية بشعة، ولكن إذا كان العلم متيناً ويمكننا البناء عليه -وما زال هذا احتمال بعيد جداً- فقد يؤدي ذلك أيضاً إلى منع الجريمة بطريقة أكثر عدلاً وكفاءة. على أي حال، يبدو لنا اليوم أن تحديد من يحصل على إخلاء سبيل مشروط يرجع جزء منه إلى مزاج القاضي. بالمقابل، يُعد اللجوء إلى العلاج النفسي أو مراكز رعاية الأطفال لحماية أولئك الذين ثَبُت أنهم نشؤوا في بيئة عنيفة وتعرضوا لسوء المعاملة ليس بالأمر السيئ.
ومع ذلك، هناك شيء ما حول البحث العلمي الحالي فيما يخص عوامل الخطر البيولوجية هذه، والتي تُعد مضللة بعض الشيء: فهي تفترض خطأً أن المجرمين الذين يجب أن نكون قلقين بشأنهم هم القتلة والمغتصبون وغالباً المختلون عقلياً والخارجون عن السيطرة. ليس من المستغرب إذاً أن تكون المؤشرات البيولوجية التي يجري البحث عنها في هذا المجال مرتبطة دائماً بطريقة ما بالعدوانية والاندفاع والانحراف الأخلاقي وتعاطي المخدرات. إنه يتجاهل المجرمين الذين يرتدون البدلات الرسمية ولديهم سيطرة كبيرة على أنفسهم، وغالباً على مؤسسات كبيرة وقوية. هؤلاء هم الذين يُسمون بالمجرمين ذوي الياقات البيض، ونجدهم على عكس القتلة والمتحرشين بالأطفال يحرصون عادة على كسب رضا من حولهم.
جرائم أصحاب الياقات البيض
لكن جرائم أصحاب الياقات البيض، سواء كانت شركات متورطة بتجارة المخدرات تخفي النتائج المقلقة بشأن منتجاتها، أو شركات صناعة السيارات التي تغش اختبارات الانبعاثات، أو الأنظمة الفاسدة التي تختلس مليارات الدولارات من المال العام، هي أكثر تكلفة من الجريمة المتعارف عليها في المال والصحة والأرواح المفقودة؛ وكم تُقدر تكلفتها تماماً هو شيء من الصعب حسابه، ولكن بالرجوع إلى بعض المقاييس الموثوقة فإنها تعد أكثر كلفة بـ 50 مرة وأكثر فتكاً بـ 13 مرة. في المملكة المتحدة على سبيل المثال؛ في حين أن جرائم العنف تكلف ما يُقدر بنحو 124 مليار جنيه استرليني سنوياً، بما في ذلك تكاليف تحقيقات الشرطة والمحاكم والنفقات في السجون والخسارة في الإنتاجية، تقدر تكلفة جرائم الاحتيال بمفردها 190 مليار جنيهاً استرلينياً سنوياً.
إن منع مثل هذا النوع من الجرائم ليس بالأمر السهل -فهو يتطلب تغيير هياكل وضع الحوافز والإجراءات البيروقراطية للمؤسسات، وليس إجراء بعض التحليلات البيولوجية لأولئك العاملين فيها فحسب. ومع ذلك، فإن أمام التنبؤ البيولوجي فرصة للعب دور فعّال هنا، وهو مساعدتنا في اختبار أولئك الذين يتنافسون على أبرز المناصب في المجتمع؛ وبالتالي الأكثر خطورة عليه.
خذ مثالاً "المضطرب العقلي في الشركات"، فهذا الشخص يفتقر إلى المشاعر مثل التعاطف، والشعور بالذنب، والندم، ومع ذلك يمكنه التلاعب بالآخرين من خلال جاذبيته والقدرة على الإقناع من أجل تحقيق مصالحه الذاتية. وخلافاً للمضطرب العقلي السريري، فإن هذا الشخص ليس بالضرورة مندفعاً أو معرضاً للنوبات العنيفة والمعادية للمجتمع. في الواقع، في أثناء المقابلات المصممة لاختبار الاضطراب العقلي، تُعد هذه الأنماط ذكية نسبياً في إخفاء طبيعتها.
والأكثر من ذلك، هناك أدلة على أن هؤلاء الأفراد ينجذبون بشكل خاص إلى المؤسسات الكبيرة والقوية، وهم في الواقع الأكثر تمثيلاً بين أوساط المهنيين في الشركات. وبينما لا يوجد الكثير من الأبحاث حول هذا الأمر، يمكننا أن نتوقع نتائج مماثلة في السياسة للأسباب نفسها: بمجرد وصول المضطرب العقلي إلى إدارة مؤسسة قوية، فهو يعتبر في موقع ممتاز للسعي وراء أهدافه الأنانية دون عوائق، حيث يستطيع التلاعب طوال الوقت بالبيئة الأخلاقية من حوله لتطبيع السلوكيات المشبوهة، في الوقت الذي يكون فيه زملاؤه الأصحاء حذرين منها.
هل يمكن أن يكون هناك مؤشرات بيولوجية تساعد في التعرف على مثل هؤلاء الأفراد؟ يجري ببطء رسم خريطة للعلاقة بين الارتباطات العصبية والاضطراب العقلي، وكذلك الأسس الجينية لما يسمى بـالأفراد القساة وغير العاطفيين. حتى السمات الشخصية مثل النرجسية المتطرفة قد يكون لها بعض الارتباطات الهرمونية.
من المؤكد أن تحديد هذه الشخصيات الخادعة من خلال مؤشرات بيولوجية معينة ليس مستحيلاً، ولكن العلم يحتاج أولاً إلى تركيز اهتمامه على المجرمين ذوي الياقات البيض، وفهم أفضل لعوامل الخطر التي تنطوي عليها.
كيفية تطبيق التنبؤ البيولوجي
لا بد وأن نتساءل كيف سيتم ذلك، ومن قبل مَنْ، فمن الصعب تخيل مجلس إدارة يطالب المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي بالخضوع لفحص الدماغ أو اختبار جيني. ومع ذلك، قد تكون الشركات نفسها هي التي تدفع باتجاه هذا التغيير في معايير التدقيق الخاصة بها وذلك من أجل شيء واحد: حيث يبدو أن القادة الذين لديهم صفات المضطربين عقلياً يحدّون من ثروة المساهمين في المستقبل بشكل يمكن التنبؤ به.
في حين أن هذا سوف يتطلب حتماً تحولاً ثقافياً في كيفية تقييمنا للمدراء والقادة المحتملين. وجدير بالذكر أن بعض الدول تستخدم بالفعل مقاييس (ضعيفة) لكشف الاضطراب العقلي لدى الأفراد المرشحين لمناصب حرجة للسلامة العامة، مثل قوات الشرطة والإطفاء، وكذلك العاملين في محطات الطاقة النووية. إن الأفراد في المستويات العليا من الهيئات السياسية القوية والمؤسسات، هم مثل الذين يعملون في محطات الطاقة النووية، يشغلون مواقع يمكن أن تلحق ضرراً كبيراً. وبينما نفهم كذلك الأسس البيولوجية لسمات الشخصية الماكرة، فقد يبدو من الحماقة عدم فحص المرشحين الذين يتدافعون للوصول إلى أقوى المناصب.
إن تطبيق التنبؤ البيولوجي على هذا المستوى سيثير أيضاً قلقاً أقل بشأن الظلم، حيث يتم عادة ارتكاب الجرائم المتعارف عليها من قبل الأشخاص المستضعفين أصلاً: فأعداد المشردين والذين لديهم صعوبات في التعلّم وأفراد الجماعات المهمشة كبيرة في السجون. وإضافة علامات التنبؤ البيولوجية وغيرها من التدابير التدخلية في حياتهم لوصمهم قد يزيد من حدة عيوبهم.
ماذا عن النُخب المتميزة بالفعل والتي تتنافس على مناصب الرئاسة التنفيذية أو المناصب الرئاسية الأخرى؟ في الواقع، بما أن النُخب على وجه التحديد هي الأكثر أهلية لإمكانية ضبط هذه التقنية الناشئة في مواجهة بعض النتائج غير المرغوب فيها، فمن الحكمة أن يصبحوا هم أول من يخضعون إليها وليس السارق المشرد، أضف هذا إلى حقيقة أن القادة الأقوياء يتصرفون في الخفاء، وظهور قدرة متطوّرة على التمييز بين القائد الرائع ووالقائد المضطرب عقلياً ستكون مفيدة في الوقت الحالي من أجل إحباط القيام بمخطط احتيالي.