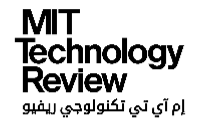ترزح الولايات المتحدة اليوم تحت وطأة وباءين: فيروس كورونا، ووحشية الشرطة.
يعمل كلا الوباءين على نشر العنف الجسدي والنفسي. كما يستهدف كل منهما ذوي البشرة السوداء والبنية، قتلاً وإنهاكاً، وإن كان بصورة غير متناسبة. ويعتمد كلاهما على التكنولوجيا التي نصممها ونستغلها بأشكال مختلفة ومن ثم نستخدمها، سواء أكانت تتبع الاختلاط أو التعرف على الوجوه أو وسائل التواصل الاجتماعي.
غالباً ما نلجأ إلى التكنولوجيا لمساعدتنا على حل مشاكلنا. ولكن عندما يقوم المجتمع بتعريف وتأطير وتمثيل الناس من ذوي البشرة الملونة على أنهم "المشكلة"، تتسبب هذه الحلول بضرر يفوق نفعها في أغلب الأحيان. لقد صممنا تقنيات التعرف على الوجوه، التي تستهدف المشتبه بهم بناء على لون البشرة. لقد قمنا بتدريب أنظمة حساب المخاطرة المؤتمتة، التي تسم ذوي الأصول اللاتينية -وبشكل غير متوازن- بأنهم مهاجرون غير شرعيين. لقد ابتكرنا خوارزميات لاحتساب الدرجة الائتمانية تسم ذوي البشرة السوداء على وجه الخصوص بأنهم يمثلون مخاطرة كبيرة، وتمنعهم من شراء البيوت والحصول على القروض والعثور على الوظائف.
وبالتالي، فإن المسألة التي يجب أن نواجهها هي ما إذا كنا سنستمر في تصميم واستخدام أدوات تخدم مصالح العنصرية وتفوق العرق الأبيض أم لا.
ولكن بالطبع، هذا التساؤل ليس جديداً على الإطلاق.
حقوق غير مدنية
في العام 1960، واجه قادة الحزب الديمقراطي مشكلة خاصة بهم: كيف أمكن لمرشحهم الرئاسي جون كينيدي أن يعزز تأييده الانتخابي آنذاك من قِبل ذوي البشرة السوداء وغيرهم من الأقليات العرقية؟
قام إيثييل دي سولا بول، وهو مختص بارز في العلوم السياسية لدى جامعة إم آي تي، بالتقرب منهم باستخدام أحد الحلول. حيث جمع بول بيانات الناخبين من الانتخابات الرئاسية السابقة، ولقمها إلى آلة معالجة رقمية جديدة، وقام بتطوير خوارزمية لنمذجة سلوك الناخبين، وتمكن من توقع المواقف السياسية التي تؤدي إلى أفضل النتائج، وقدم توصياته إلى مشرفي حملة كينيدي على هذا الأساس. أطلق بول شركة جديدة باسم سيميولماتيكس كوربوريشن، ونفذ خطته. نجح بول، وفاز كينيدي في الانتخابات، وقد أثبتت النتائج فعالية هذه الطريقة الجديدة في النمذجة التنبؤية.
تفاقمت التوترات العرقية في فترة الستينيات، وأتى الصيف الطويل الحار في سنة 1967. احترقت العديد من المدن على امتداد الولايات المتحدة، من بيرمنجهام في ألاباما وصولاً إلى روتشيستر في نيويورك ومينيابوليس في مينيسوتا، وغير ذلك. تظاهر الأميركيون من ذوي البشرة السوداء احتجاجاً على القمع والتمييز الذي كانوا يتعرضون إليه في ذلك الوقت من قِبل النظام القضائي الجنائي الأميركي. ولكن الرئيس جونسون وصف هذه الأحداث حينها بأنها "فوضى مدنية"، وشكّل لجنة كيرنر لتحديد أسباب "أحداث الشغب في الأحياء المهمشة". قررت اللجنة الاستعانة بخدمات سيميولماتيكس.
كانت شركة بول جزءاً من مشروع يتبع لداربا (وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية) يهدف إلى تغيير اتجاه حرب فييتنام، ولهذا كانت تعمل بجد على تحضير حملة دعائية ونفسية ضخمة ضد مقاتلي الفييتكونج. كان الرئيس جونسون تواقاً إلى استخدام تكنولوجيا التأثير على السلوك من سيميولماتيكس لتهدئة الأحداث المحلية التي كانت تعاني منها الولايات المتحدة، لا ضد الأعداء الأجانب وحسب. وفي إطار ما أطلقت عليه الشركة اسم "دراسة إعلامية"، قامت سيميولماتيكس ببناء فريق تحول إلى حملة مراقبة ضخمة في "المناطق التي تعاني من أحداث الشغب"، التي استحوذت على اهتمام الأميركيين في صيف 1967.
انطلقت فرق مؤلفة من ثلاثة أشخاص إلى مناطق الشغب في ذلك الصيف. حدّدت الفرق الشخصيات الإستراتيجية في أوساط ذوي البشرة السوداء، وإجراء مقابلات معها. وبعد ذلك، قامت الفرق بتحديد أفراد آخرين من السكان وإجراء مقابلات معهم، وذلك في كل مكان عام، بدءاً من محلات الحلاقة وصولاً إلى الكنائس. قامت الفرق بتوجيه أسئلة إلى السكان حول آرائهم في التغطية الإعلامية التي تركز على "أحداث الشغب". ولكن الفرق جمعت بيانات كثيرة أخرى أيضاً، مثل بيانات حول حركة الناس في المدينة أثناء الأحداث، ومع من كانوا يتحدثون قبل الأحداث وخلالها، وكيف استعدوا للنتائج. جمعت الفرق أيضاً بيانات حول استخدام أكشاك الدفع لقاء المرور في الطرقات، ومبيعات محطات الوقود، ومسارات الحافلات. تمكنت الفرق من التغلغل في أوساط السكان بذريعة محاولة فهم تأثير التغطية الإعلامية الذي أدى إلى إشعال وتفاقم "أحداث الشغب"، ولكن جونسون والقادة السياسيين كانوا يحاولون حل المشكلة، وكانوا يريدون استخدام المعلومات التي جمعتها سيميولماتيكس من أجل تتبع تدفق المعلومات خلال التظاهرات لتحديد الشخصيات المؤثرة، والقضاء على قيادات المحتجين.
ولكنهم لم يحققوا هذا بشكل مباشر. فلم يقتلوهم أو يزجوهم في السجون أو "يغيّبوهم" سراً.
ولكن، وبحلول نهاية الستينيات، ساعدت هذه المعلومات على بناء ما أصبح يُعرف باسم: "أنظمة معلومات العدالة الجنائية". انتشرت هذه الأنظمة عبر العقود التالية، ووضعت أساس التصنيف العنصري، والأساليب البوليسية التنبؤية، والمراقبة عرقية الطابع. وتركت خلفها إرثاً من ملايين المساجين من النساء والرجال من ذوي البشرة السوداء والبنية.
إعادة تأطير المشكلة
العرق الأسود وذوو البشرة السوداء. يمثل كلاهما مشكلة مستمرة للولايات المتحدة، بل يمكنني القول إنها مشكلة تمس العالم بأسره. عندما بدأ استخدام تتبع الاختلاط في بداية الوباء، كان من البديهي أن ننظر إليه على أنه أداة مراقبة صحية ضرورية ولكنها بريئة. كان فيروس كورونا هو المشكلة، وبدأنا بتصميم تكنولوجيات مراقبة جديدة على شكل أنظمة لتتبع الاختلاط، ومراقبة درجة الحرارة، وتطبيقات تحديد مناطق الخطر، وذلك للمساعدة على مواجهة الوباء.
ولكن حدث شيء غريب ومأساوي في نفس الوقت. لقد اكشفنا أن ذوي البشرة السوداء واللاتينيين والسكان الأصليين تعرضوا بشكل خاص إلى الإصابة والآثار السيئة. وفجأة، أصبحنا أيضاً مشكلة على مستوى البلاد بأسرها، وأصبحنا مصدر خطر يهدد بانتشار الفيروس بصورة غير متناسبة على فئات محددة. وتعاظم هذا الخطر بعد أن أدى مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض البشرة -في تلك الحادثة المأساوية- إلى خروج الآلاف من المحتجين إلى الشوارع. عندما بدأت أحداث النهب والشغب، أشارت أصابع الاتهام إلينا، نحن معشر ذوي البشرة السوداء، على أننا مصدر خطر على القانون والنظام، وتهديد لنظام يدعم هيمنة العرق الأبيض. يدفعك هذا إلى التساؤل: متى ستتحول هذه التكنولوجيات -التي صممناها في المقام الأول لمحاربة كوفيد-19- إلى سلاح تستخدمه قوات إنفاذ القانون من أجل إخماد الخطر المفترض الذي يمثله ذوو البشرة السوداء على سلامة البلاد؟
إذا لم نرغب في أن تُستخدم تقاناتنا لتعزيز العنصرية، يجب أن نحرص على ألا ننسب المشاكل الاجتماعية -مثل الجريمة أو العنف أو المرض- إلى ذوي البشرة السوداء أو البنية. عندما نفعل هذا، فنحن نخاطر بتحويل هؤلاء الأشخاص إلى ذات المشاكل التي نحاول التخلص منها عن طريق هذه التقانات.